
لقد مثّلت السُّلطويّة على الدّوام، أحد أهم أشكال الأنظمة غير الدّيموقراطية، والتي يُعدُّ العالم العربي مَشتلاً لإنتاجها بصفةٍ مستمرّة. كُلُّ ذلك له علاقةٌ بمجموعةٍ من العواملِ المترابطة ذات الصّبغة الاجتماعيّة والثقافيّة بالأساس، دون إهمال تبعات الحِقبة الاستعمارية وما أفرزته من تبعيّة سياسية للغرب، الذي وجد على ما يبدو في الأنظمة السُّلطويّة العربيّة حليفاً استراتيجيّاً لخدمة مصالحه الاقتصادية، وإلاّ فكيف نفسّر ذلك الموقف الغامض للدّول الغربيّة تُجاه الانتهاكات المتكرّرة والمتواصلة لحقوق الإنسان ببلدان العالم الثالث، وفي طليعتها العالم العربي، فلا أحد ينكر الطّابع المُلتبس الذي تعاطت به دول الاتّحاد الأوروبي مع الإعدامات التي وقعت مؤخّراً في “مصر”، ولا طريقة تعاطي “ترامب” مع قضيّة مقتل الصّحفي السّعودي “جمال خاشقجي”.
إنّ المُطّلع على التّاريخ العربي، سيجدُ أنّ التّسلُّط قد انصهر في عدّة قوالب مؤسساتية رسخت مفهوم السلطة السياسية والدولة بالعالم العربي. تلك الدولة في الواقع لا تعدو أن تكون في طبيعة بنياتها الإدارية والدستورية أكثر من امتداد تاريخي لما يسميه المفكر “عبد الله العروي” بالدولة السلطانية. ولعل الدور الذي لعبته طريقة تأويل القيم الثقافية والدينية المؤسسة لمشروعية هذه الدولة، شكل مبررا ومنطلقا تحليليا لدى بعض المستشرقين مثل “برنار ليفيس” “Bernad Lewis” و”إرنست رونو” “Ernest Renan” و”صامويل هنتغتون” “Samuel Huntington” لتأكيد فرضية تعارض الإسلام مع القيم الديمقراطية، ومن ثمة استحالة دمقرطة المجتمعات العربية و الإسلامية.
غير أن أحداث ” الرّبيع العربي ” والتي انطلقت أولى شراراتها من تونس سنة 2011، جاءت لتنسف تلك الفرضية ولتؤكد تطلع الشعوب العربية إلى التغيير رغم كل الإكراهات، وهذا ما عكسته في الحقيقة مجموعة من الشعارات السياسية التي رفعها المحتجونفي كل من “تونس” و”مصر” و”المغرب” وغيرها من بلدان الحراك.ولقد عكس ذلك بشكل من الأشكال منسوب الوعي الاجتماعي المتنامي الذي بدأ يتبلور بهذه البلدان في تزامن مع النقلة النوعية التي تشهدها هذه الشعوب على المستوى الديمغرافي. ولعلّ ذلك هو ما جعل الأبحاث في العلوم الاجتماعية في الآونة الأخيرة تركز على” الرّبيع العربي” كمعطى جديد لتناول ودراسة العالم العربي من حيث طرحها لفرضيات الانتقال الديمقراطي وإمكانية بناء مشروع حداثي بالبلدان العربية.

لكن من جهة مقابلة، فالمسار الذي قطعته هذه الأحداث وطبيعة مخرجاتها جعلت من هذا الرّبيع خريفاً تعمُّه الحروب التي ما تزال مستمرة إلى اليوم في “ليبيا” و”سوريا” و”اليمن”، مروراً بإمساك الجيش بزمام الأمور في “مصر” بعد الانقلاب الذي نفّذته المؤسّسة العسكريّة على رئيسٍ محسوبٍ على تيّارِ الإخوانِ المسلمين. وحتّى الدّول التي نجحت في التّعاطي مع الحراك بطريقة استراتيجية يشوب مسلسل الإصلاحات السياسية والدّستورية بها عدّة عراقيل مرتبطة بقدرة الدّولة العميقة على ضبط تلك الإصلاحات وفق مقاربة سُلطويّة، أفرغتها من حمولتها الدّيمقراطية. فإذا استحضرنا النّموذج المغربي، نلاحظ بأنّ المخزن كثقافة وكأليات للتّحكُّم؛ ساهم في تدبير وفرملة الإصلاحات المُعتمدة على عدّة مستويات سياسيّة واقتصاديّة، ممّا أدّى إلى مراقبة مخرجاتها حتّى لا تُحدث تغييراً يُقلِّصُ من هيمنةِ الدّولة العميقة. لذا، فإنّ كيفيّة التّخلُّص من الإرث المخزني يُعدُّ من أهمِّ الرّهانات التي تواجه مُسلسل الدَّمقرطة في بلد مثل “المغرب”، الذي أصبح فيه الشّباب هو الفاعل الرّئيسي في جُل المسيرات الاحتجاجية على أرض الواقع، أو في صفحات العالم الافتراضي. الأمر الذي جعل هذه الفئة الدّيمغرافية تلعبُ دوراً تعبويّاً نتيجةً لإمساكها بزمامِ وسائل التّواصل الاجتماعي أكثر من غيرها، مع ما ترتّب عن ذلك من تحوُّلات فيما يخُصُّ التّمثّل الاجتماعي لـ”السّياسة” و”السُّلطة” و”الدّولة”.
يمكننا القول إذن، أنّ أحداث ”الرّبيع العربي”؛ تتمثّلُ من جانبها الإيجابي في كونها فتحت الباب أمام الشّباب لكي يُساهم في إعادة تأسيس العلاقة بين “الدّولة” و”المجتمع” على قيم جديدة، أهمُّها المُحاسبة والمسؤولية وفق تصوُّر اجتماعي جديد ومُغاير، فلم يَعُد يرى في هذه الدّولة مِلكاً تاريخيّاً للحاكم، ولم يعُد الشّأن العام شأناً خاصّاً له، ولم يعُد الفقر قدَراً يجبُ على المواطن الإيمان به. بل على العكس من ذلك تماماً، لقد أصبح المواطن يعتبر غياب العدالة الاجتماعية وتقاعُس مؤسّسات الدّولة والنّظام السّياسي عن أداء أدوارهم، من أهم الأسباب الرّئيسيّة لأوضاعه المزرية، التي يعيشها على المستوى السُّوسيو_اقتصادي، وبات “الفساد” عدُوَّهُ الأوّل والأخير.
غير أنّهُ أمام كلِّ هذهِ المؤشّرات الإيجابية، يصعُبُ على المُحلّل في تناوله للأحداث والدّينامية التي تشهدها بُلدان شمال إفريقيا والشّرق الأوسط مُنذ يناير 2011، أن يخوض في نقاش حول حتميّة الإصلاح دون أن يَسقط في جدليَّةِ التَّشاؤمِ والتَّفاؤلِ في الوقت نفسه، لأنّ أسباب استمرارية السُّلطويّة في التجذُّر لازالت قائمةً بغضّ النّظرِ عن التّحوُّل الحاصل على المُستويَين الاجتماعي والدّيمغرافي.

فارتفاع نسبة الأميّة ومحدودية الوعي السّياسي إضافةً إلى طبيعة القيم الثّقافية المحددة للعلاقات والنظام الاجتماعيين، تعتبر من أبرز العوامل التي تشرح أسباب تأييد بعض الشّرائح الاجتماعية للأنظمة السُّلطويّة وشكّها في مصداقية مطالب الفئات الأخرى المطالبة بالتغيير. لهذا فإنّ التغيير بهذه البلدان هو في حدّ ذاته معادلة يصعُب فهمها فضلاً عن حلّها، في غياب فهم دقيق ومعمّق لهذا التّناقض القائم بين التغيير والاستمرارية في إطار المخاض العسير الذي تمر منه اليوم عملية ولادة الديمقراطية ببلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط. ويحيل التلاقح بين هذه العناصر في أبعاده الجدلية، على كون أهم عائق يقف حجرة عثرة أمام عملية التحديث، يتجسد أساسا في محدودية هذا الحراك وفي نسبية هذه الدينامية الاجتماعية الملاحظة، إضافة إلى عدم قدرة المجتمعات على إعادة تنظيم بنياتها بشكل عقلاني يسمح ببناء مجتمع مدني قوي، يكون عبارة عن إطار لإنتاج وعي ديمقراطي مضاد للقيم السلطوية التي ينتجها الفضاء السياسي. كل ذلك ينضاف إلى قدرة الدولة على اختراق المجتمع عبر بناء مجموعة من الشبكات الزبونية التي سهلت عليها التحكم في دينامية هذا الأخير وبالتالي الحد من التأثير الاجتماعي والسياسي للأفعال الصادرة عن القوى الاجتماعية المطالبة بالتغيير.
إن المنطق الريعي إلى جانب المقاربة القمعية يُعدان في هذا الصدد من أهم الآليات التي ساعدت نخب وأجهزة الدولة العميقة بالعالم العربي على ضبط الحراك الاجتماعي، وأسهمت بشكل حاسم في تدجين القوى المعارضة من خلال قدرتها على الالتفاف على مكاسب الإصلاح ومن ثم توجيهها وفق منطق سلطوي نحو إعادة إنتاج السلطوية بدل الديموقراطية. ولذا، فإن مسعى الحفاظ على المكتسبات الدستورية والسياسية التي أتت بفضل حراك ”الربيع العربي” ظل يشكل موضوع انتقاد لحصيلة الأداء الحكومي في هذه البلدان.
وفي المغرب مثلا، أصبح حزب العدالة والتنمية أمام عدة رهانات سياسية مرتبطة بتأثير هذه الحصيلة على مصداقيته كحزب قدم نفسه انتخابيا على أنه بديل سياسي قادر على تخليق الحياة السياسية وتحقيق العدالة الاجتماعية، لكن محك الممارسة السياسية والتسيير جعله يتبنى مجموعة من الاختيارات على المستويين السياسي والاقتصادي تتناقض بشكل كبير مع برنامجه الانتخابي الذي يقوم على عدة مرتكزات أهمها الإصلاح والتنمية.

وارتباطاً بالحالة المغربية دائما، فقد أفرزت سنوات تسيير حزب العدالة والتنمية للشأن العام عدة نتائج أهمها بروز صراع غير مباشر وضمني مع الدولة العميقة، وبالأخص منذ ما عرف بـ “البلوكاج” الحكومي سنة 2016، حيث انتقل بعض زعماء هذا الحزب وعلى رأسهم عبد الإله بنكيران في خطابتهم السياسية إلى إبراز أوجه هذا الصراع من خلال التأكيد على وجود مخطط لإضعاف الحزب والقضاء عليه سياسيا. ولذلك فإن التحول الحاصل على مستوى العلاقة القائمة بين إسلاميي العدالة والتنمية، ثم نخب وأجهزة الدولة العميقة/المخزنية يترجم بنحو ما أهميةَ ذلك التنافس غير المعلن حول موارد السلطة بين الطرفين، ويعبر في المقابل عنعدم نجاح الإسلاميين في كسب ثقة الدولة العميقة التي تشك في مصداقية خطابهم ونواياهم السياسية. هذا المعطى في الواقع، يبقى دائم الحضور في العلاقة القائمة بينهما وبالأخص منذ أن أصبح أعضاء الحزب يوظفون انتصارهم الانتخابي كمورد سياسي يقوي نفوذهم داخل المؤسسات السياسية، وهذا بالضبط ما يذكرنا ولو بشكل نسبي بتجربة جماعة الإخوان المسلمين في مصر، حين قامت هذه الأخيرة باستثمار فوزها الانتخابي بطريقة جعلتها تدخل في صدام سياسي مع مؤسسة الجيش، التي ظلت تعتبر نفسها هي الفاعل والممثل الرئيسي للإرادة الوطنية مند الانقلاب العسكري لسنة 1952.
إنّ أحد أهم خصوصيات الظاهرة السلطوية في مصر هي تحكم الجيش في قواعد اللعبة السياسية والسيطرة على دواليب القطاع الاقتصادي، وهو ما سهل على المؤسسة العسكرية ضمان نفوذها السياسي. وفي هذا السياق يشكل اسلوب الرئيس السيسي في الحكم بدولة مصر، ترجمةً حرفية للهيمنة السلطوية لهذه المؤسسة على مفاصل الدولة، والأكثر من ذلك هو أنها مؤسسة لا تقبل إطلاقا بوجود فاعلين سياسيين أخرين ينافسونها في المشروعية التاريخية المكتسبة منذ الفترة الناصرية وإلى اليوم.
ومما تجدر الإشارة إليه، هو أن الدور السياسي للمؤسسة العسكرية ليس محصورا فقط في الحالة المصرية، بل أيضاً، نلاحظ ذلك في حالات عربية أخرى مثل الجزائر التي يضطلع فيها الجيش بدور مفصلي منذ استقلال هذا البلد. وإذا تمعنا جيدا في التاريخ السياسي للجزائر، سنجد بأن جل رؤساء الجمهورية منتمون للجيش، ولكن ما تشهده الحياة السياسية الجزائرية في الآونة الأخيرة، من تطورات بسبب رفض أطياف كبيرة من الشعب للولاية الخامسة لبوتفليقة قد يشكل منعطفا يحمل عدة مؤشرات على بداية تآكل النظام السلطوي في البلاد، وبروز انفراج قد يفتح الباب أمام إصلاحات سياسية ودستورية تضع حدا لتحكم الجيش كدولة عميقة، وتحد من تحكمّ نخبه في الحياة السياسية.
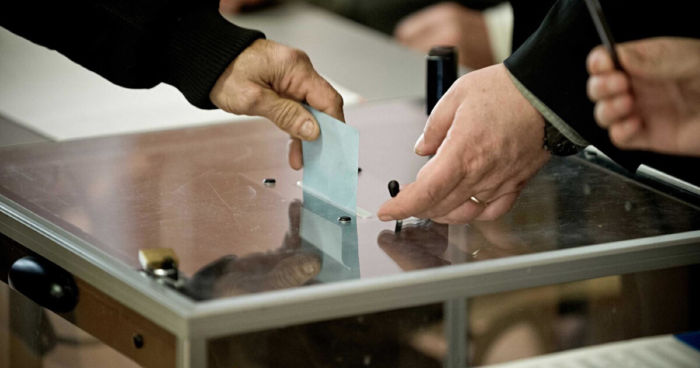
إنّ دراسة الظاهرة السلطوية بدول شمال افريقيا والشرق الأوسط، تقترن بطبيعة آليات سيطرة وهيمنة الدولة العميقة التي تشترط دراستها الإلمام بالمسار التاريخي للدولة الحديثة بهذه البلدان، وكذلك الكيفية التي حسمت بها نخب الدولة العميقة الصراع السياسي لصالحها منذ السنوات الأولى للاستقلال. إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال إهمال المعطيات التاريخية التي تؤكد قدرة أجهزة هذه الدولة العميقة تاريخيا على دولنة المجتمع واستحضار تيمة الفتنة والفوضى كرد فعل استباقي يصبو إلى تحجيم وعرقلة كل محاولة للإصلاح تنبع من الأسفل. ولعل من خصائص الظاهرة السلطوية هي القدرة على ضبط تحرك المجتمع وخلق ثقافة الخوف التي شكلت لمدة سنوات أهم مورد سيكولوجي يغذي الظاهرة السلطوية.
إنّ مخرجات ” الربيع العربي” قد أبانت بشكل ما عن محدودية إسهامها في التأثير والتغيير، نظرا لعدة عوامل منها ما هو خارجي مرتبط في بالدور السلبي الذي لعبته قوى دولية وجهوية حاولتإجهاض عملية الإصلاح ببلدان مثل؛ “تونس” و”سوريا” و”ليبيا”، ومنها ما هو راجع الى خصوصية المجتمعات العربية التي لم تستطع بعد بلورة قراءة نقدية لتراثها الثقافي بما يساعدها على خلق قطيعة ابستمولوجية مع جملة من القيم السلبية، وخلق مرجعية قيمية جديدة تخدم عملية التحديث والدمقرطة الكاملة، على الرغم من أهمية الدينامية الاجتماعية التي تعرفها.
إنّ ما تحتاجه هذه المجتمعات هو ثورة ثقافية تحرر العقول من كل الحواجز القيمية والذهنية التي تعرقل مسار إعادة بناء نظامها السياسي والاجتماعي على أسس عقلانية تضع حدا لتلك التأويلات المحافظة، والتي بسببها بقي التسلط متجذرا اجتماعيا عبر توفيرالإرث الثقافي والسياسي الغطاء القيمي لإضفاء الشرعية على هذا التسلط. وهذا هو أهم عنصر في مقاربة ظاهرة السلطوية، فمن خلاله يمكننا فهم سبب بقاء العالم العربي أرضا خصبة لإنتاج التسلط رغم كل المتغيرات الحالية، وتفسير ضعف القدرة السببية التي تمتلكها القوى الاجتماعية المدافعة عن قيم التغيير والديمقراطية.







